من أجل ثقافة أفريقية وحدوية
أ. عبد الرؤوف بابكر السيّد
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربيّة، كلية الآداب والتربية
جامعة التحدّي ـ سرت
وقد تمّت المشاركة بها في الندوة الدوليّة للمثقفين الأفارقة والتي جاءت تحت شعار"دور المثقفين الأفارقة في تفعيل آليّات الاتحاد الأفريقي"
(كما نشرت بمجلة - شمال جنوب – التي تصدر عن قسم اللغة الفرنسيّة بكلية الآداب – مصراتة- جامعة 7 أكتوبر – العدد الثاني ـ الصيف 2008)
لا أظننا بحاجة للإشارة إلى إيقاع العصر المتسارع الذي خلق مفارقة كبيرة بين ماض لم تفعّله التقنيات الحديثة، وحاضر قرّبت فيه هذه الوسائل المسافات واختصرت المساحات، وأصبح الإنجاز الأكبر في الزمن الأقل سمة العصر وخاصّيته الأولى.. من هنا كان طرح" أهمية استثمار الوقت لخلق ثقافة وحدويّة" ضمن محاور الندوة الدولية للمثقفين الأفارقة والتي جاءت تحت شعار "دور المثقفين الأفارقة في تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي" منطلقا من ذات السمة والخاصّية، فكيف يمكن اختزال الزمن واستثماره لخلق لحمة ثقافية رغم تعدّد اللغات واللهجات بعموم أفريقيا؟ وكيف يمكن جسر الهوّة التي خلقتها وعمّقتها الحملات الاستعمارية في سبيل استلاب الإنسان الأفريقي وجعله تابعا على الدوام..
. إنّ أقصر الطرق إذا ما وضعنا في حسباننا الفواصل والفوارق والعوائق التي كانت نتاجا طبيعيّا للعزلة التي فرضتها عدة من العوامل ومنها الطبيعيّة الجغرافية ـ في الماضي ـ التي عزلت المجاميع البشرية فيها، والتي أسهمت في توليد هذا العدد الهائل من اللغات واللهجات.. ومنها السياسية التي فرضتها الحقب الاستعمارية ، وعمقت عن عمد الفوارق بين أبناء القارة ، ورسمت لهم الحدود وفق مصالحها وأطماعها. إنّ أقصر الطرق لخلق ثقافة وحدوية ينبغي النظر إليها من زاوية الوصل بعد أن تمّ تشخيص الفصل الذي حاول المستفرقون والمستشرقون تجسيده بين شمال الصحراء وجنوبها، وبين شرقها وغربها ، من خلال عدد هائل من الكتابات ، وغزو فاضح للغات، وتخريب متعمّد للثقافات..
فهناك العديد من الكتاب المستفرقين والأفارقة على حد سواء ينظرون إلى وجود ثقافات أفريقية عديدة لا مجرد ثقافة واحدة(*) وهناك من يذهب إلى أن وجود منطقتين ثقافيتين مختلفتين لكل منهما تاريخ مختلف وتقاليد مختلفة(**) في وقت لا تعرف الثقافة الأفريقية الاختلاف بقدر ما تعرف التعدد والتنوّع الأمر الذي يثريها في إطارها العام. فهي بمجملها تنتمي لبنية واحدة تعرضت للاستباحة والهيمنة من بنية أخرى تمثلت في البنية المادية الغربية شمال القارة أو جنوب الصحراء. فالقيم والتراتبية الاجتماعية والأسر الممتدّة والقبلية والعصبية والعنصرية عرقا ولونا ولغة ودينا ، ومرجعيّة غيبية وماضويّة، واستهلاكية، كل ذلك يجعل كامل القارة في دائرة ثقافة بنية واحدة، ومع ذلك فهناك تنوع وتعدّد ثقافي إذا ما سعينا لرسم خارطة له فإنه يجب أن نأخذ في اعتبارنا الملامح الطبيعيّة والتاريخ والنظام الاقتصادي في الإنتاج والتوزيع واللغة المستخدمة في الحديث والمعتقدات الدينية ومزاولة الرقص والموسيقى والفن، وكل العوامل الأخرى التي تسهم في الثقافة. إن التنوع والتعدد الثقافي لا يعني التفكك والاختلاف أو الانفصال، بل يجب تشجيع الثقافات المحلية كي تنمو وتزدهر.
ولعلّي أتفق مع بروفيسور كيمانغا ماسالا من جامعة كنشاسا في وضع خطوات مسبقة لإعادة صياغة الوسط الثقافي الاجتماعي القائم أهمها: تأكيد وإثبات هوية المجموعة حيث يجب فهم التقاء الثقافات كالتقاء أشخاص يمثلون تفردا تاريخيا مختلفا يؤدّي فيه الاحترام المشترك والتفاهم إلى الانفتاح على الجميع والذي يؤدّي بدوره إلى احترام الثقافات، والابتعاد عن أشكال القوّة والهيمنة، بحيث يكون التقاءً خلاّقاً يفضي إلى علاقات تمازج اجتماعي، وإرساء مفهوم تبادل الرؤى والمساواة بين الثقافات.(1)
" في شهر فبراير/شباط 1976، عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة على الطريق بين إيبادان ولاغوس في نيجيريا، ألقي القبض على رجل بتهمة حيازة قطع أثرية اتجه الظن إلى أنها مسروقة، وكان الرجل يحمل ملء كيسين من القطع المنحوتة من البرونز والخشب، أصرّ على أنها جميعا ملكه الخاص. وقد اكتشفت الشرطة بعد ذلك أنه كان يقول الحقيقة، إذ إن هذا الرجل ـ الذي كان حديث عهد باعتناق الإسلام ـ كان يعيش ويعمل في إيبادان في جماعة مشتركة. وكانت آلهة اليوروبا التي وجدت تماثيلها المنحوتة في حوزته تحمل على نحو منتظم إلى المدينة بواسطة العمّال المتنقّلين، حيث تخدم الاحتياجات الروحيّة في البيوت المؤقتة التي ينزل بها الحرفيّون غير المستقرّين وصغار كتبة المدينة وغيرهم من العمّال. غير أنه حدث بعد حين أن تحوّل رئيس الجماعة المشتركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الإسلام، وبدأ بدوره يهدي جيرانه إلى هذه الديانة. وبعد أن اعتنق المشتبه فيه الإسلام، أفهم أنه لابدّ أن ينبذ رموزه الدينية السابقة إذا أريد لمقر الجماعة أن يصبح مقرا لائقا للدين الجديد. ولم يتحمّل الرجل فكرة التدمير المادّي لهذه الرموز، فقد قرّر أن يحملها ويعود بها إلى مقرّها الأصلي في قريته، حيث استقرّت الآن".(2)
يقول وولي شوينكا(3) عن هذه الحادثة أنها تصوّر نمطا شائعا لحركة الصيغ الثقافيّة ومظاهرها المادّية، وتعتبر نموذجا صادقا لبقاء القيم الثقافية ـ بل وتجدّدها ـ في مواجهة صور الهيمنة الدينيّة وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة من الناحية الاجتماعيّة. وما كان صحيحا في عام 1976 يمكن ببساطة أن نرى أنه كان أكثر شيوعا بكثير في تلك الفترة الأشد تقلبا وعنفا للسيطرة الخارجيّة في أفريقيا. عندما أصبح شعب بأكمله، بكل نظمه الاجتماعيّة وأنماطه الاقتصاديّة وصور تعبيره الفنّي، خاضعا لاستراتيجيّات تستهدف استغلاله إلى الحد الأقصى لخدمة مصالح خارجيّة.
ما أود الإشارة إليه في هذه الورقة أن الهيكل السياسي الذي أرساه الاتحاد الأفريقي في 9. 9. 99 ينبغي أن يسهم المثقفون الأفارقة في العمل على الوحدة الثقافية بعناية واهتمام يتجسد في تفعيل الفنون الأفريقية بتنوّعها وتعدّدها وثرائها، بالاهتمام بها رسما ونحتا ولونا وموسيقى ، شعرا ونثرا، مسرحا وخطابة ورقصا شعبيا.. إنها الأقرب إلى وجدان الجماهير ، والغذاء الروحي، والطريق الأقصر للتواصل والالتحام والتوحّد..
فالغناء والموسيقى والرقصات الشعبية والأغاني والمسرح وأشرطة الخيّالة التي يمكنها أن تحمل على عاتقها إزاحة الكم الهائل من الحواجز النفسية والمعوّقات والعراقيل والعقبات التي كما أشرنا عمدت الجغرافيا السياسية من خلال الدور الاستعماري على تعميقها وإحداث شروخ كبيرة بين المجتمعات الأفريقية.
إن الموسيقى الحقيقيّة لشعوب أفريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت راسخة باعتبارها المنبع التجديدي للإرادة الثقافيّة للقارة. ودورها ووظيفتها الاجتماعيّة أكثر من أيّ شكل فنّي آخر هي التي يمكن من خلالها إدراك الحقيقة الثقافية المعاشة للشعوب. فإذا كان الشعر ديوان العرب فإن الموسيقى هي رباط القارة الأفريقية ، والتي ظلّ دورها في تحقيق التكامل والترابط الاجتماعي هو أقوى مظاهر الحياة الثقافية في القارة.. وظلّ الفنان الموسيقي يمثل ظاهرة ثقافية بالغة الحيويّة والفعالية سواء كان دوره هو دور الوسيط الروحي، أو المرفّه في المناسبات الاجتماعية، أو المؤرخ.." فالموسيقى في أفريقيا لها تأثير وقدسية، فهي من أهم مركبات الثقافة الأفريقية، ومتغلغلة في المجتمع والحياة بقدر غير قليل... الموسيقى في أفريقيا مثل الهويّة يحملها المرء معه دائما سواء كان لوحده أو وسط مجموعة"(4)
والفنون المسرحية كانت في معظم الحالات امتدادا لفن الموسيقى أو تعبيرا مركبا من خلاله، غير أنها تحمل شواهد أكثر تحديدا على عمليات الانتقال والتحوّل من الصور التقليديّة إلى صور التكيّف المتطوّر.
كما كانت المهرجانات، وخاصة مهرجان الحصاد السنوي والذي يجمع بين الحدّادين والنسّاجين والصبّاغين وناقشي الخشب والراقصين فتقدّم مثالا على استمرار وجود الإبداع الجماعي حتى في نطاق التقسيم الذي يفتت المجتمعات المحلّية، والذي طبّقه رجال الإدارة الاستعماريّة على عمّالهم. ففيها كانت كل عام تتدفّق الأسر المشتتة على المدينة متخذة من الفن سبيلا إلى تأكيد نظرتها الأصيلة إلى العالم..
وعن الرقص، يسوق الدكتور أ.ك. كوراكو من جامعة غانا تفسيرا عن تعبير إحدى الراقصات في غانا نقلا عن الأستاذ ماوير أوبوكو: " الحياة بالنسبة لنا هي الرقصة، بل إنها مجرد رقصة فهي بإيقاعاتها وحلقاتها وصخبها مجرد رقصة، فالرقص هو الحياة مصبوبة في قالب درامي. بل الرقص هو سجل المجموعة العرقية، بالنسبة لنا الرقص لغة، هو صورة من صور التعبير الذي ينقل صورتها إلى العقل عبر القلب. وبنظرة أعمق إنها ـ أي الرقصة ـ العمل والتاريخ الاجتماعي والحالة الاقتصاديّة، ومعتقداتنا الدينية، إنها تحوي أحزاننا وأفراحنا، إنها حياتنا وأرواحنا.(5)
إضافة إلى تقنية رسم الخرز، والنحت الديني لدى اليوروبا والباولي والباتوكا..
وتشكل الكلمة عاملا مساعدا في دور الخطيب والشاعر ، خاصة حين تتجسد المفردة في الأغنية الأفريقية..فالنص الشعري الغنائي عادة يتميّز بلمس الأوتار الذاتية الحساسة لدي الجموع، مصحوبا بوهج من النغم، ودفء في الصوت، وتجاوب مع الإيقاع..
وبما أن العصر بإيقاعه المتسارع ، وضرورة كسبه في مواجهة تحدّيات العصر التي تواجه الأفارقة. إن الاهتمام بالفنون مدخلا لخلق ثقافة أفريقية وحدويّة، إضافة إلى التداخل والتواصل بالمهرجانات الشبابية ، مع دور أساس للإعلام المسموع والمرئي والمقروء سيخلق تواصلا، يخلق بدوره مزاجا متقاربا بل وواحدا لدى الشعوب الأفريقية، ويقوّي أواصر الارتباط ويخلق لوحة هذا الفضاء متناغمة في داخل الإنسان الأفريقي..
عليه فإن الإعلام بوسائله المختلفة يقع عليه العبء الأكبر في حشد الطاقات الفنية لجعل الساحة الأفريقية على امتداد القارة، مهرجانات ومسرحيات وموسيقى ورقصات وأغان يسهم فيها كل الفنانين والمثقفين والكتاب والأدباء، لخلق التوحد الوجداني الذي سيسهم كثيرا في خلق الثقافة الوحدوية، ومن ثم تكون الأرضية الصلبة لقيام الولايات المتحدة الأفريقية، فالبنى التحتية للمجتمعات هي التي تسهم في نجاح ما تنتجه البنى الفوقية من مخططات استراتيجية جدّ هامة وخطيرة.
الجانب الأهم الثاني في كسب الوقت هو من خلال دور التعليم في القارة الأفريقية، لتعليم النشء تاريخ أفريقيا العام بدءا من الحملات الاستعمارية وملاحم النضال والكفاح والمقاومة التي سطرها الأفارقة الأسلاف في كل قطر أفريقي لإبراز حجم الهجمة الاستعمارية التي تستهدف الجميع، إضافة إلى جغرافيتها ومحاصيلها واقتصادياتها وثرواتها ومناخها ودياناتها واجتماعياتها وخصائصها وسماتها.
إن تعليم النشء في المدارس تاريخ أفريقيا العام سيقرب الصورة ويرسم الفضاء في وجدانهم خاصة إذا ما استخدمت الوسائل التقنية الحديثة في تقريب الصورة وتجسيدها، فشريط[عمر المختار] على سبيل المثال يستطيع أن يختزل ويجسد تاريخ الجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا.
من خلال ما تقدّم فإن هذه الورقة تطرح عددا من آليات العمل الذي من شأنه أن يستثمر الوقت ويختزله انسجاما مع السمة الأولى والخاصية المتميزة للعصر، وهي الإنجاز الأضخم في الزمن الأقل، وتتمثل هذه الآليات في التوصيات التالية:
1_ أن يرتبط المثقفون بالجماهير الأفريقية ويسخروا كل قدراتهم وإمكاناتهم لخلق حالة من الفرح الدائم والدفق المعنوي المستمر والتواصل الذي يقطع الطريق على الاستلاب والانبهار بالآخر..
2_ أن تؤدّي أجهزة الإعلام والثقافة في كل الأقطار الأفريقية دورها في خلق مناخ لهذا التواصل من أجل ثقافة أفريقية متوحدة ثرية بتعدّدها وتنوّعها..
3_ أن يتم الاهتمام بالمهرجانات الشبابية والملتقيات الفنية والمهرجانات والمسابقات والندوات والمؤتمرات والبرامج الفنية المشتركة ، لاسيما دعم لقاء ثقافي فنّي دوري يمكن أن تحتضنه مدينة معينة أو تتم استضافته في مدينة أفريقية كل عام، أسوة بالملتقيات الرياضيّة..
4_ أن تندرج في المناهج الدراسية مفردات خاصة بتاريخ أفريقيا ونضالاتها ليتعرف النشء وحدة النضال والكفاح ضد المستعمر.
5_ أن توضع استراتيجية إعلاميّة تنفذها قناة أفريقية تهتم بالشأن الأفريقي الموحّد ويجد كل أفريقي نفسه فيها، على أن تلتزم بالحياد والموضوعية أثناء التوترات والصراعات التي قد تنشأ بين الأقطار الأفريقية أو يتسبب فيها الصراع الإثني في إذكائها..
6_ أن يتم إنشاء مركز لترجمة العديد من الإبداعات الأفريقية لتجاوز التعدد اللغوي، وتزود المكتبات بها مستهدفا خلق نوع من التواصل الثقافي والمعرفي بالشأن الأفريقي، ولتسمح المكتبات في المؤسسات التعليمية بتعميق الدراسات الأكاديمية التي يمكن أن يتجه نحوها طلاب الدراسات العليا.
7_ العمل على غرس ثقافة العمل الطوعي بين الشباب الأفريقي، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية الطوعيّة في دائرة منح الشباب فرصة للبذل والعطاء غير المحدود من أجل الارتقاء بالبيئة والمجتمع الأفريقي.
هوامش:
(*) بهادور تيجاني الأوغندي، ذو الأصل الهندي، علي شلش،الأدب الفريقي،عالم المعرفة171،1993،ص18.
(**) المستفرق الألماني هاينزيان، Jahn.Neo-African Lit.pp.19-20 نقلا عن المرجع السابق ص14..
(1)كيمانغالا ماسالا، نحو فلسفة تمازج ثقافي، أوراق المؤتمر العلمي(التداخل والتواصل في أفريقيا) الخرطوم يناير2006، الكتاب الثاني،ص99.
(2) وولي شوينكا، الفنون في أفريقيا، تاريخ أفريقيا العام، م7،ص547.
(3) المرجع السابق نفسه.
(4) عبد الرحمن شلقم، أفريقيا القادمة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،1982، ص74.
(5) نقلا عن المرجع السابق،ص78-79.
.
فهناك العديد من الكتاب المستفرقين والأفارقة على حد سواء ينظرون إلى وجود ثقافات أفريقية عديدة لا مجرد ثقافة واحدة(*) وهناك من يذهب إلى أن وجود منطقتين ثقافيتين مختلفتين لكل منهما تاريخ مختلف وتقاليد مختلفة(**) في وقت لا تعرف الثقافة الأفريقية الاختلاف بقدر ما تعرف التعدد والتنوّع الأمر الذي يثريها في إطارها العام. فهي بمجملها تنتمي لبنية واحدة تعرضت للاستباحة والهيمنة من بنية أخرى تمثلت في البنية المادية الغربية شمال القارة أو جنوب الصحراء. فالقيم والتراتبية الاجتماعية والأسر الممتدّة والقبلية والعصبية والعنصرية عرقا ولونا ولغة ودينا ، ومرجعيّة غيبية وماضويّة، واستهلاكية، كل ذلك يجعل كامل القارة في دائرة ثقافة بنية واحدة، ومع ذلك فهناك تنوع وتعدّد ثقافي إذا ما سعينا لرسم خارطة له فإنه يجب أن نأخذ في اعتبارنا الملامح الطبيعيّة والتاريخ والنظام الاقتصادي في الإنتاج والتوزيع واللغة المستخدمة في الحديث والمعتقدات الدينية ومزاولة الرقص والموسيقى والفن، وكل العوامل الأخرى التي تسهم في الثقافة. إن التنوع والتعدد الثقافي لا يعني التفكك والاختلاف أو الانفصال، بل يجب تشجيع الثقافات المحلية كي تنمو وتزدهر.
ولعلّي أتفق مع بروفيسور كيمانغا ماسالا من جامعة كنشاسا في وضع خطوات مسبقة لإعادة صياغة الوسط الثقافي الاجتماعي القائم أهمها: تأكيد وإثبات هوية المجموعة حيث يجب فهم التقاء الثقافات كالتقاء أشخاص يمثلون تفردا تاريخيا مختلفا يؤدّي فيه الاحترام المشترك والتفاهم إلى الانفتاح على الجميع والذي يؤدّي بدوره إلى احترام الثقافات، والابتعاد عن أشكال القوّة والهيمنة، بحيث يكون التقاءً خلاّقاً يفضي إلى علاقات تمازج اجتماعي، وإرساء مفهوم تبادل الرؤى والمساواة بين الثقافات.(1)
" في شهر فبراير/شباط 1976، عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة على الطريق بين إيبادان ولاغوس في نيجيريا، ألقي القبض على رجل بتهمة حيازة قطع أثرية اتجه الظن إلى أنها مسروقة، وكان الرجل يحمل ملء كيسين من القطع المنحوتة من البرونز والخشب، أصرّ على أنها جميعا ملكه الخاص. وقد اكتشفت الشرطة بعد ذلك أنه كان يقول الحقيقة، إذ إن هذا الرجل ـ الذي كان حديث عهد باعتناق الإسلام ـ كان يعيش ويعمل في إيبادان في جماعة مشتركة. وكانت آلهة اليوروبا التي وجدت تماثيلها المنحوتة في حوزته تحمل على نحو منتظم إلى المدينة بواسطة العمّال المتنقّلين، حيث تخدم الاحتياجات الروحيّة في البيوت المؤقتة التي ينزل بها الحرفيّون غير المستقرّين وصغار كتبة المدينة وغيرهم من العمّال. غير أنه حدث بعد حين أن تحوّل رئيس الجماعة المشتركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الإسلام، وبدأ بدوره يهدي جيرانه إلى هذه الديانة. وبعد أن اعتنق المشتبه فيه الإسلام، أفهم أنه لابدّ أن ينبذ رموزه الدينية السابقة إذا أريد لمقر الجماعة أن يصبح مقرا لائقا للدين الجديد. ولم يتحمّل الرجل فكرة التدمير المادّي لهذه الرموز، فقد قرّر أن يحملها ويعود بها إلى مقرّها الأصلي في قريته، حيث استقرّت الآن".(2)
يقول وولي شوينكا(3) عن هذه الحادثة أنها تصوّر نمطا شائعا لحركة الصيغ الثقافيّة ومظاهرها المادّية، وتعتبر نموذجا صادقا لبقاء القيم الثقافية ـ بل وتجدّدها ـ في مواجهة صور الهيمنة الدينيّة وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة من الناحية الاجتماعيّة. وما كان صحيحا في عام 1976 يمكن ببساطة أن نرى أنه كان أكثر شيوعا بكثير في تلك الفترة الأشد تقلبا وعنفا للسيطرة الخارجيّة في أفريقيا. عندما أصبح شعب بأكمله، بكل نظمه الاجتماعيّة وأنماطه الاقتصاديّة وصور تعبيره الفنّي، خاضعا لاستراتيجيّات تستهدف استغلاله إلى الحد الأقصى لخدمة مصالح خارجيّة.
ما أود الإشارة إليه في هذه الورقة أن الهيكل السياسي الذي أرساه الاتحاد الأفريقي في 9. 9. 99 ينبغي أن يسهم المثقفون الأفارقة في العمل على الوحدة الثقافية بعناية واهتمام يتجسد في تفعيل الفنون الأفريقية بتنوّعها وتعدّدها وثرائها، بالاهتمام بها رسما ونحتا ولونا وموسيقى ، شعرا ونثرا، مسرحا وخطابة ورقصا شعبيا.. إنها الأقرب إلى وجدان الجماهير ، والغذاء الروحي، والطريق الأقصر للتواصل والالتحام والتوحّد..
فالغناء والموسيقى والرقصات الشعبية والأغاني والمسرح وأشرطة الخيّالة التي يمكنها أن تحمل على عاتقها إزاحة الكم الهائل من الحواجز النفسية والمعوّقات والعراقيل والعقبات التي كما أشرنا عمدت الجغرافيا السياسية من خلال الدور الاستعماري على تعميقها وإحداث شروخ كبيرة بين المجتمعات الأفريقية.
إن الموسيقى الحقيقيّة لشعوب أفريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت راسخة باعتبارها المنبع التجديدي للإرادة الثقافيّة للقارة. ودورها ووظيفتها الاجتماعيّة أكثر من أيّ شكل فنّي آخر هي التي يمكن من خلالها إدراك الحقيقة الثقافية المعاشة للشعوب. فإذا كان الشعر ديوان العرب فإن الموسيقى هي رباط القارة الأفريقية ، والتي ظلّ دورها في تحقيق التكامل والترابط الاجتماعي هو أقوى مظاهر الحياة الثقافية في القارة.. وظلّ الفنان الموسيقي يمثل ظاهرة ثقافية بالغة الحيويّة والفعالية سواء كان دوره هو دور الوسيط الروحي، أو المرفّه في المناسبات الاجتماعية، أو المؤرخ.." فالموسيقى في أفريقيا لها تأثير وقدسية، فهي من أهم مركبات الثقافة الأفريقية، ومتغلغلة في المجتمع والحياة بقدر غير قليل... الموسيقى في أفريقيا مثل الهويّة يحملها المرء معه دائما سواء كان لوحده أو وسط مجموعة"(4)
والفنون المسرحية كانت في معظم الحالات امتدادا لفن الموسيقى أو تعبيرا مركبا من خلاله، غير أنها تحمل شواهد أكثر تحديدا على عمليات الانتقال والتحوّل من الصور التقليديّة إلى صور التكيّف المتطوّر.
كما كانت المهرجانات، وخاصة مهرجان الحصاد السنوي والذي يجمع بين الحدّادين والنسّاجين والصبّاغين وناقشي الخشب والراقصين فتقدّم مثالا على استمرار وجود الإبداع الجماعي حتى في نطاق التقسيم الذي يفتت المجتمعات المحلّية، والذي طبّقه رجال الإدارة الاستعماريّة على عمّالهم. ففيها كانت كل عام تتدفّق الأسر المشتتة على المدينة متخذة من الفن سبيلا إلى تأكيد نظرتها الأصيلة إلى العالم..
وعن الرقص، يسوق الدكتور أ.ك. كوراكو من جامعة غانا تفسيرا عن تعبير إحدى الراقصات في غانا نقلا عن الأستاذ ماوير أوبوكو: " الحياة بالنسبة لنا هي الرقصة، بل إنها مجرد رقصة فهي بإيقاعاتها وحلقاتها وصخبها مجرد رقصة، فالرقص هو الحياة مصبوبة في قالب درامي. بل الرقص هو سجل المجموعة العرقية، بالنسبة لنا الرقص لغة، هو صورة من صور التعبير الذي ينقل صورتها إلى العقل عبر القلب. وبنظرة أعمق إنها ـ أي الرقصة ـ العمل والتاريخ الاجتماعي والحالة الاقتصاديّة، ومعتقداتنا الدينية، إنها تحوي أحزاننا وأفراحنا، إنها حياتنا وأرواحنا.(5)
إضافة إلى تقنية رسم الخرز، والنحت الديني لدى اليوروبا والباولي والباتوكا..
وتشكل الكلمة عاملا مساعدا في دور الخطيب والشاعر ، خاصة حين تتجسد المفردة في الأغنية الأفريقية..فالنص الشعري الغنائي عادة يتميّز بلمس الأوتار الذاتية الحساسة لدي الجموع، مصحوبا بوهج من النغم، ودفء في الصوت، وتجاوب مع الإيقاع..
وبما أن العصر بإيقاعه المتسارع ، وضرورة كسبه في مواجهة تحدّيات العصر التي تواجه الأفارقة. إن الاهتمام بالفنون مدخلا لخلق ثقافة أفريقية وحدويّة، إضافة إلى التداخل والتواصل بالمهرجانات الشبابية ، مع دور أساس للإعلام المسموع والمرئي والمقروء سيخلق تواصلا، يخلق بدوره مزاجا متقاربا بل وواحدا لدى الشعوب الأفريقية، ويقوّي أواصر الارتباط ويخلق لوحة هذا الفضاء متناغمة في داخل الإنسان الأفريقي..
عليه فإن الإعلام بوسائله المختلفة يقع عليه العبء الأكبر في حشد الطاقات الفنية لجعل الساحة الأفريقية على امتداد القارة، مهرجانات ومسرحيات وموسيقى ورقصات وأغان يسهم فيها كل الفنانين والمثقفين والكتاب والأدباء، لخلق التوحد الوجداني الذي سيسهم كثيرا في خلق الثقافة الوحدوية، ومن ثم تكون الأرضية الصلبة لقيام الولايات المتحدة الأفريقية، فالبنى التحتية للمجتمعات هي التي تسهم في نجاح ما تنتجه البنى الفوقية من مخططات استراتيجية جدّ هامة وخطيرة.
الجانب الأهم الثاني في كسب الوقت هو من خلال دور التعليم في القارة الأفريقية، لتعليم النشء تاريخ أفريقيا العام بدءا من الحملات الاستعمارية وملاحم النضال والكفاح والمقاومة التي سطرها الأفارقة الأسلاف في كل قطر أفريقي لإبراز حجم الهجمة الاستعمارية التي تستهدف الجميع، إضافة إلى جغرافيتها ومحاصيلها واقتصادياتها وثرواتها ومناخها ودياناتها واجتماعياتها وخصائصها وسماتها.
إن تعليم النشء في المدارس تاريخ أفريقيا العام سيقرب الصورة ويرسم الفضاء في وجدانهم خاصة إذا ما استخدمت الوسائل التقنية الحديثة في تقريب الصورة وتجسيدها، فشريط[عمر المختار] على سبيل المثال يستطيع أن يختزل ويجسد تاريخ الجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا.
من خلال ما تقدّم فإن هذه الورقة تطرح عددا من آليات العمل الذي من شأنه أن يستثمر الوقت ويختزله انسجاما مع السمة الأولى والخاصية المتميزة للعصر، وهي الإنجاز الأضخم في الزمن الأقل، وتتمثل هذه الآليات في التوصيات التالية:
1_ أن يرتبط المثقفون بالجماهير الأفريقية ويسخروا كل قدراتهم وإمكاناتهم لخلق حالة من الفرح الدائم والدفق المعنوي المستمر والتواصل الذي يقطع الطريق على الاستلاب والانبهار بالآخر..
2_ أن تؤدّي أجهزة الإعلام والثقافة في كل الأقطار الأفريقية دورها في خلق مناخ لهذا التواصل من أجل ثقافة أفريقية متوحدة ثرية بتعدّدها وتنوّعها..
3_ أن يتم الاهتمام بالمهرجانات الشبابية والملتقيات الفنية والمهرجانات والمسابقات والندوات والمؤتمرات والبرامج الفنية المشتركة ، لاسيما دعم لقاء ثقافي فنّي دوري يمكن أن تحتضنه مدينة معينة أو تتم استضافته في مدينة أفريقية كل عام، أسوة بالملتقيات الرياضيّة..
4_ أن تندرج في المناهج الدراسية مفردات خاصة بتاريخ أفريقيا ونضالاتها ليتعرف النشء وحدة النضال والكفاح ضد المستعمر.
5_ أن توضع استراتيجية إعلاميّة تنفذها قناة أفريقية تهتم بالشأن الأفريقي الموحّد ويجد كل أفريقي نفسه فيها، على أن تلتزم بالحياد والموضوعية أثناء التوترات والصراعات التي قد تنشأ بين الأقطار الأفريقية أو يتسبب فيها الصراع الإثني في إذكائها..
6_ أن يتم إنشاء مركز لترجمة العديد من الإبداعات الأفريقية لتجاوز التعدد اللغوي، وتزود المكتبات بها مستهدفا خلق نوع من التواصل الثقافي والمعرفي بالشأن الأفريقي، ولتسمح المكتبات في المؤسسات التعليمية بتعميق الدراسات الأكاديمية التي يمكن أن يتجه نحوها طلاب الدراسات العليا.
7_ العمل على غرس ثقافة العمل الطوعي بين الشباب الأفريقي، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية الطوعيّة في دائرة منح الشباب فرصة للبذل والعطاء غير المحدود من أجل الارتقاء بالبيئة والمجتمع الأفريقي.
هوامش:
(*) بهادور تيجاني الأوغندي، ذو الأصل الهندي، علي شلش،الأدب الفريقي،عالم المعرفة171،1993،ص18.
(**) المستفرق الألماني هاينزيان، Jahn.Neo-African Lit.pp.19-20 نقلا عن المرجع السابق ص14..
(1)كيمانغالا ماسالا، نحو فلسفة تمازج ثقافي، أوراق المؤتمر العلمي(التداخل والتواصل في أفريقيا) الخرطوم يناير2006، الكتاب الثاني،ص99.
(2) وولي شوينكا، الفنون في أفريقيا، تاريخ أفريقيا العام، م7،ص547.
(3) المرجع السابق نفسه.
(4) عبد الرحمن شلقم، أفريقيا القادمة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،1982، ص74.
(5) نقلا عن المرجع السابق،ص78-79.
.

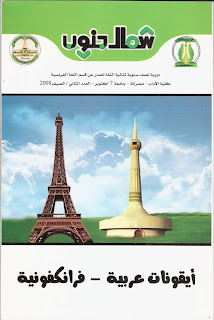








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق